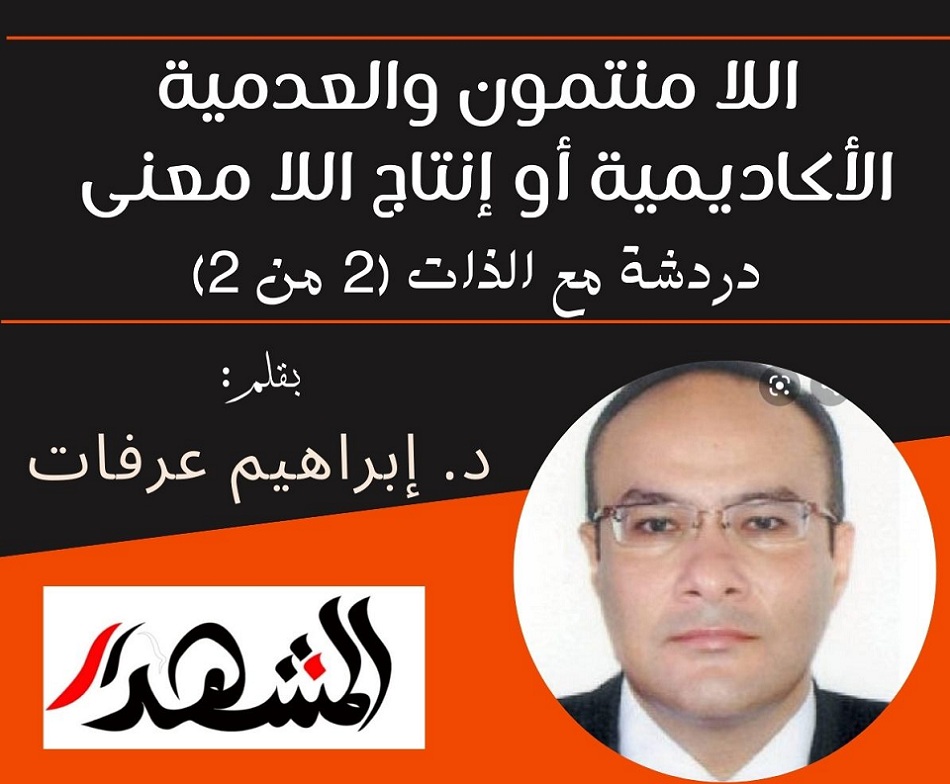عندما تختلف الصفة عن الموصوف، والاسم عن الفعل، والدال عن المدلول، واللفظ عن المعنى، وكليات العلوم الاجتماعية عن رسالة العلوم الاجتماعية يضطرب وجود تلك الكليات، بل ويصبح بعضها والعدم سواء. فلا معنى للشيء إذا فقد جوهره وهويته ورسالته. وهذا ما حدث بأسف وأسى كبيرين في حقل الإنسانيات والعلوم الاجتماعية العربية. فبدلاً من أن تقوم مؤسساتها بشرح وتوضيح ونقد وتصحيح المعني، راح بعضها يهذي وينتج، بل ويعيد إنتاج اللا معنى. ولا بد من التماس بعض العذر لتلك المؤسسات، لأنها في نهاية الأمر ليست إلا جزءًا صغيراً من مجتمع أكبر ينتج بدوره كل يوم كثيراً من اللا معنى. فلدينا مجتمعات عربية ينادي الناس فيها السباك مثلاً بالدكتور، ويسمون ميكانيكي السيارات بالباشمهندس، والضابط بالباشا، والمشاغبين بالنشطاء، ومثيري الفتن بالمؤثرين وناشري التفاهة بصناع المحتوى، ويجاملون العاطل فيسمونه self-employed، والحبل هكذا على الجرار في فصل الدال عن المدلول وقتل المعنى، ليسمى الانقلاب ثورة والقهر حرية والديكتاتورية مشاركة والسرقة إعادة هيكلة والاحتكار خصخصة والتغريب حداثة.
وبنفس هذا التناقض بين الدال والمدلول في المجتمع الكبير، يتسابق مجتمع الإنسانيات والعلوم الاجتماعية العربية في تعميق التناقض بين دالاته ومدلولاته ليغرق الساحة باللا معنى بطرق وأشكال مختلفة، من بينها بعض الدرجات العلمية التي تكشف شخصيات من يحملها عن خلوها من المعنى. وأطروحات عديدة تسمى مجازاً "علمية" لكن عناوينها وخططها وبنيتها ومضمونها ومنهاجيتها واستخلاصاتها تكشف عن غرقها في اللا معنى. ومشروعات تخرج عبثية يوضع عليها اسم الطلاب، لكن جهات مشبوهة تقبع تحت بئر السلم، هي عادةً ما تقوم بها ما يكرس في ذهن الطلاب صورةً معيبة عن العلم، وأنه بأكمله نشاط بلا معنى. وأمية منهجية مطبقة تؤكد الغياب التام للمعنى، وخريجون لو سألتهم في أبسط أساسيات التخصص الذي حصلوا على درجاتهم العلمية فيه، لن يعطونك إجابة لها معنى. وكلمات كبيرة تتردد عن الدراسات البينية والعرضية والطولية والعابرة للاختصاصات وحديث عن الـ interdisciplinarity,multidisciplinarity and transdisciplinarity وغير ذلك من الكلمات الفخيمة التي لا تزيد عن تريندات، أو أعمال ركيكة تنقل حرفياً عن بعضها copy paste، بجانب سرقات علمية وعبوديات أكاديمية يستغل القوي فيها الضعيف، وترجمات حرفية عن صفحات أجنبية لموضوعات لا علاقة لنا بها، لا نحن نشبهها ولا هي تشبهنا، ناهيك عن لي عنق نظريات مستعارة يتم إنزالها على واقع ليس لها وليست منه، لتخرج عنها في النهاية توصيات بلا معنى.
قولوا لي مثلاً ما قيمة نظرية العقد الاجتماعي التي تفترض أن الدولة تشكلت بتوافق إرادي حر بين الأفراد، بينما تكونت الدول العربية إما نتيجة القهر الاستعماري أو بالاستيلاء كما وصفه الماوردي في الأحكام السلطانية. قد تكون نظرية العقد الاجتماعي قيمة في سياقها الأوروبي، لكنها بلا معنى في السياق العربي. أو حدثوني عن نظريات ما بعد الحداثة التي تقوم على الشك في الحقائق الكبرى والهويات الثابتة، بينما لا تزال المجتمعات العربية متمسكة بالهويات المرجعية البدائية كالقبيلة والطائفة، أو بالمرجعيات الإطارية الكبيرة كالأمة. قد تكون نظريات قيمة في سياقها الأوروبي لكنها بلا معنى في السياق العربي. أو أقنعوني بجدوى النظريات النسوية الراديكالية النافرة في السياقات الدينية والثقافية العربية. قد تكون لها قيمة عند من أبدعها، لكنها بلا معنى لمن اتبعها. أو قولوا لي ما المعنى الذي تقدمه نظرية الحراك الاجتماعي الغربية التي تؤكد على أن الفرد فاعل مستقل، بينما المجتمعات العربية ما زالت تعتمد على القبيلة والأسرة والجماعة في صناعة الهوية واتخاذ القرار. قد تكون نظرية مفيدة في الأرض التي نبتت فيها، لكنها بلا معنى في الأرض التي جُلبت إليها. أو قولوا لي ما المعنى الذي افادتنا به نظرية السوق الحرة التي تدعو إلى تقليص دور الدولة إلى حده الأدنى بينما تعتمد المجتمعات العربية حتى اليوم على الدولة كمصدر للوظائف والخدمات، فضلاً عن أن الدولة العربية على عكس الدولة الغربية ما زالت تعشق من يستجديها ويلهث وراءها، فكيف لها أن تقبل بتصغير دورها والحد من حجمها؟ قد تكون تلك النظرية مفيدة في سياقها الأوروبي، لكنها بلا معنى في السياق العربي. أو حدثوني عن نظرية الدولة القومية التي تجعل من الدولة عنواناً للحداثة، وتقدمها على أنها الإطار الطبيعي للتنظيم السياسي، بينما ما يزال الدين والطائفة والمذهب في المجتمعات العربية يشكلون عناصر محورية في الحياة العامة والخاصة على السواء. قد تكون نظرية قيمة في سياقها الغربي، لكنها بلا معنى عميق في السياق العربي. أو كلموني عن النظرية الليبرالية التي تفترض الحياد الديني والأيديولوجي للدولة، وهو أمر لا ينهض عليه دليل في السياق العربي. أو عن النظرية السلوكية التي تركز على التصرفات القابلة للملاحظة وتتجاهل القيم والدوافع الدينية والروحية والصوفية، بل وأحياناً الخرافية المنتشرة في العالم العربي. أو كلموني عن نظريات المجتمع المدني التي تفترض وجود مساحة حرة تسمح لمن يرغب بتكوين جمعيات وسيطة بين الدولة والمجتمع، فيما نعرف كلنا أن تلك الجمعيات تنشأ في السياق العربي نشأة فوقية لتظهر وتختفي بأمر الدولة. أو كلموني عن نظريات التحول الديمقراطي التي تفترض أن النمو الاقتصادي والتعليم يؤديان معاً إلى الديمقراطية، وهو كلام ليس له معنى في السياق العربي حيث ترسخ السلطوية برغم النمو الاقتصادي والتوسع في التعليم، بما في ذلك بكل أسف تعليم العلوم الاجتماعية.
هذه مجرد نماذج لإنتاج اللا معنى، أو للعدمية الأكاديمية إن شئتم، التي يجب ألا نكابر فننكرها، وإنما علينا أن نتواضع ونعترف بوجودها حتى نتمكن من مواجهتها. أعلم أن كلماتي خشنة بعض الشيء. لكن الأفضل أن نقسو على أنفسنا قبل أن يقسو الآخرون علينا. وقد علمتني التجربة العملية، وما تزال، أن قسوة منتقدينا من شاغلي المواقع العامة في محلها في معظم الأحيان، كما أنها لا تنبع من فراغ. فهم يروننا ويرصدون حالنا ويتابعونا ويحاول بعضهم أن يفهمنا وأن يستفيد منا. لكننا لا نعطيهم ما يريدون كما لا نعطي أنفسنا فرصة لكي نعدل مساراتنا. فقد انشغلت كليات عربية عديدة للعلوم الاجتماعية بمقاييس وممارسات لها العجب، لا تنتج غير أصفار وتكثر من اللا معنى. أما صناع القرار فيريدون كلاماً له معنى وخريجون لهم معنى وأوراق لها معنى. ومع اختفاء المعنى، بل وانتاج اللا معنى سلّم شاغلو المواقع العامة من المهتمين عن كثب بالعلم أمرهم لله في تلك المعاهد والكليات. فإن أصلحت من حالها رحبوا بها واستفادوا مما تنتجه. وإن لم تصلح تركوها لمصيرها لعلها تستقيم أو تتحول، والعوض على الله، إلى نواد تنشغل بالبحث الترفيهي أو إلى مصانع تضخ شهادات، لا يجد من يحملها لنفسه أي معنى عندما يخرج إلى الحياة العملية.
لكن لماذا اتسع انتاج اللا معنى؟ اتسع في تقديري لأسباب كثيرة أهمها تضخم ظاهرة اللا منتمين إلى العلوم الاجتماعية.
اللا منتمون
ولتكن البداية بالمنتمين. فالمنتمون إلى العلوم الاجتماعية هم نساء ورجال يتعاملون بشكل مكثف مع الأفكار، يطورونها ويختبرونها بالنقد قبل النقل وبالاستنارة وليس فقط بالاستعارة. ومن يتعامل مع الأفكار عادة ما يلازمه القلق. وهذا هو حال المنتمين إلى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. فمن أكثر منهم تماساً مع هموم الناس، وأوجاع المجتمع وآلام الوطن؟ من غيرهم يبحث في دموية التاريخ، ومؤامرات السياسة، ومظاهر الظلم الاقتصادي ومشكلات القهر الاجتماعي؟ مثلهم لا يعيش إلا والأرق يرافقه واللوعة تصاحبه. المسؤولية عندهم، وليس النفعية، أول وأهم شرط لممارسة العلم الاجتماعي. وهم من يأمل في أن يمتليء الحقل المعرفي لعلومهم بالأصلاء ويتحسسون بشدة من اقتحامه من الدخلاء. يؤمنون بأن العلم الاجتماعي مسؤول عن الغوص في أعماق الإنسان واستشعار عذاباته، ولذا يرون علومهم علوم انتماء، عليها أن تعيد المشتغلين بها إلى المرجعيات الإطارية المناسبة ليقتربوا من فكرة المثقف العضوي، ذلك الإنسان الذي يملك معرفةً تمنحه وعياً متقدماً بكثير عن مجتمعه. لكن وعيه المتقدم هذا لا يجعله ينفصل عن الناس أو يستخف بمرجعياتهم أو يتنكر لتقاليدهم أو يستعلي على أعرافهم أو يشذ عن سردياتهم. فالمنتمي عضوياً للعلوم الاجتماعية شخص يحترم ويفهم ويبدأ من وينتهي عند المجتمع الذي يعيش فيه ويريد أن يغيره. فلا يسكن الأبراج العاجية أو يعمل بالمقاولات الأكاديمية. قد يكون غاضباً من بعض، أو حتى من كثير مما يراه في مجتمعه، لكنه لا يتصرف بتأفف أو يتنكر للأعراف التي صنعت تاريخ الناس الذين ينتمي إليهم.
بعبارة أخرى لا يستطيع المنتمي للعلوم الاجتماعية أن يؤدي دوره بدم بارد لأنه جزء من بيئته الحضارية. ومع أن البيئات الحضارية والتعليمية تنفتح على بعضها وتتفاعل فيما بينها إلا أنها، وبالتحديد في العلوم الاجتماعية، تلفظ بعضها إن أحست بأنها تُلغي أو تُستبدل. وهذا هو جوهر الصراع في العلوم الاجتماعية العربية لعقود ممتدة بين المنتمين واللا منتمين. المنتمون يشغلهم بناء علاقة متينة بين هوية العلم وهوية المجتمع ويعينهم إنتاج ما يناسب بني جلدتهم ونقل ما يلائمهم ويصقل شخصيتهم. أما اللا منتمون فيفكرون في أنفسهم أولاً فيسايرون الموضات في النظريات والفلسفات وحتى اللغات.
ولا يرفض المنتمون العرب للعلوم الاجتماعية مطلقاً الموضوعية، كما يرميهم بذلك بهتاناً اللا منتمون. لكنهم يأخذون بها كما عرفها الاقتصادي السويدي الشهير "جونار ميردال" في الدراما الآسيوية بأن تدافع عن نفسك منذ البداية. أما اللا منتمون فيتناسون أن الموضوعية، تلك الكلمة البراقة المفحمة، إنما جاءت إلى العلوم الاجتماعية العربية مع المركزية الغربية متغافلين أن تلك المركزية هي النقيض التام لفكرة الموضوعية.
كذلك فإن المنتمين للعلوم الاجتماعية يتبنون موقفاً أخلاقياً مبدئياً ضد تحويل الإنتاج البحثي والجهد التعليمي إلى فرقعات وشغل مصانع وضجيج ماكينات، أو أن يعهد بهما إلى مكاتب مقاولات تستنفع أو بالحصول من مكاتب خارجية على شرعيات مضللة، كل ما يعنيها ضبط الببليوميتريكس ومعاملات التأثير والتواجد ضمن قوائم التصنيف، التي باتت تغرق المشهد التعليمي بالأرقام لترضي الشكل وتنسى المضمون.
كذلك فإن المنتمين إلى العلوم الاجتماعية في أي مكان من العالم، وليس فقط في منطقتنا، لا يستطيعون التجرد من العواطف أو التنكر للدوافع الأخلاقية أو الانسلاخ عن منظومات القيم التي يعيشون فيها. ولا يرجع ذلك فقط لبشريتهم، وإنما لأن العلوم الاجتماعية "خلقتها كدا". فهي علوم مشاعر وقيم وتفضيلات وأفكار وأحاسيس وقناعات ودوافع وميول وترجيحات ومسافات ثقافية لا يمكن أن تتحرر من القيم، وإنما تغذي في النفس فضيلة الاصطفاف مع المقهور وإنصاف الضعيف، وترسخ في العقل قناعة الانتصار لقيم الحرية والعدل والمساواة، بما يتوافق والتعريف المحلي للعدل والمساوة والحرية. كما أنها علوم تطورت لتنوير عقول الناس وليس لمسخها وتزييف مدركاتها.
وكم تسببت تلك الالتزامات الأخلاقية في أخطار للمنتمين إلى العلوم الاجتماعية، لكنه الثمن الذي قبلوا أن يدفعوه من أجل لذة الاتساق مع الذات. لكن المنتمين على جسارتهم وكثرتهم أصبحوا قلة بين المشتغلين العرب بالعلوم الاجتماعية، إذ باتت تفوقهم عدداً وأثراً كتلة هائلة تفرغت للحياد والمشاهدة والعبث وانتزاع الغنائم، وهي كتلة اللا منتمين.
هؤلاء اللا منتمون تعنيهم الأرقام قبل الأفهام. وهم، وأنقل هنا عن كولن ويلسون في كتابه "اللا منتمي" أو The Outsider أناس يخافون بشدة على أنفسهم من الجماعة التي وجدوا أنفسهم يعيشون وسطها، لأنهم يعتقدون أن تلك الجماعة لا قيمة لها، بل وتستند إلى أساس واه وربما تكون مجرد محطة مؤقتة في حياتهم، ما يجعلهم يفضلون التفاعل القشري مع همومها وعدم الاندماج في نسيجها أو مشاركة القضايا التي تعنيها. فاللا منتمون يؤمنون بأن حياتهم أهم من كل من وما حولهم.
وهم بهذا الوصف أناس يعانون مشكلة في التموقع والتموضع وسوء التكيف مع المكان الذين يجدون أنفسهم فيه. ولهذا فإنهم يؤثرون السلامة، ويرضون بالعيش على هامش المجتمع العلمي مفضلين أن يقولوا كلاما ساكتا وأن يكتبوا في موضوعات مكرورة أو جامدة لا تعكس حاجة المجتمع ولا ترتقي لسلم الأولويات المعرفية، فضلاً عن أنهم كثيراً ما يتفرغون لمصالحهم الخاصة، حتى لو رفعوا شعار المصلحة العامة. هؤلاء اللا منتمون هم تماماً من وصفهم الفيلسوف الراحل زكي نجيب محمود ببقعة زيت تطفو على وجه الماء لتعكر صفحة العلم وتنشر التلوث، وتنتج اللا معنى. وهم ليسوا كتلةً واحدة وإنما شرائح مختلفة أعرض من بينها وبسرعة لعشر فئات تشمل:
1) الأكاديميون البيروقراط، ويعتبرون أن الاشتغال بالعلوم الاجتماعية وظيفة توفر مصدراً للدخل وموقعاً لكسب الوجاهة الاجتماعية.
2) الدخلاء البينيون ممن التحقوا بالعلوم الاجتماعية بدعاوى التكاملية والبينية ووحدة العلوم، دون أن يمضوا وقتاً كافياً في تعلم أصولها وفلسفتها.
3) النفعيون وأكاديميو البيزنس الذين يتخذون من العلوم الاجتماعية سبيلاً للتكسب سواء ببيع الكتب الجامعية لأعداد غفيرة من الطلاب، أو بالسطو على أعمال الغير، وغير ذلك من أشكال الانتهازية التي حولت بعض معاهد وكليات العلوم الاجتماعية العربية إلى مراتع لجماعات مصالح كبيرة وعجيبة.
4) الأكاديميون السواحون الذين لا يستطيعون أن يطوروا انتماءً وهم ينهون عقداً في جامعة، ليوقعوا عقداًجديداً في جامعة أخرى. يتحركون كأنهم سلع ولا يخضعون لقانون غير قانون العرض والطلب.
5) المؤدلجون الذين حولوا كليات العلوم الاجتماعية إلى منصات دعائية، يعتليها ناشطون يبرعون في الدوجماطيقية والتنمر المعرفي. وقد زخرت ساحات تدريس العلوم الاجتماعية العربية في مراحل مختلفة، بممثلين لتلك الفئة من مختلف التيارات العلمانية، والإسلامية، والنسوية، والقومية.
6) الناقلون المقلدون ممن يتبنون بلا وعي محلي النظريات والاقترابات الغربية دون تدقيق في مواءمتها للسياق الوطني، أو ينقلون حرفياً عن كتب لغيرهم ليعيدوا إنتاج ما سبق انتاجه.
7) القافزون من الخارج ويضمون بعض من أتى إلى مؤسسات العلوم الاجتماعية العربية ليعيشوا في أبراجها العاجية المريحة مستفيدين من تراث استعماري قديم يغرس المركزية الغربية، ويفترض أن الجامعات العربية ما زالت تعيش حالة تعلم مستمرة تفرض عليها الاستعانة اللا نهائية بسادة الصنعة.
8) أكاديميو السلطة والرقباء الأمنيون ممن يسخّرون مواقعهم الجامعية وأدوات الإدارة لإعادة انتاج الهيمنة، وهم أكبر من ينتج اللا معنى، بل وقتل معنى العلوم الاجتماعية في الصميم.
9) العدميون المقعرون ممن يتعمدون التشدق اللفظي والغموض اللغوي والتفاصح البلاغي ظناً أن ذلك يعمق المعرفة ويمنحهم سلطة على التخصص.
10) المتعجلون المختزلون الذين يبسّطون الظواهر الاجتماعية إلى حد التفاهة دون النظر في تعقيداتها وتراكيبها العميقة، أو يوجهون طلابهم إلى موضوعات هشة لا قيمة لها، ولا تنتج سوى أكواماً من الرسائل والأبحاث التي تنهشها الأتربة على رفوف المكتبات.
هذا المدى الواسع من اللا منتمين أوقع العلوم الاجتماعية العربية إما في فخ التبعية لفكر مستورد، أو في شراك ممارسات هزلية تقنع بأشباه المعرفة تخرّج أشباه متعلمين. والأسوأ أنه سلمها تسليم يد إلى غزاة وطغاة، وغلاة، وجناة، وجفاة.
أما الغزاة فجاء قليل منهم من الخارج بقناعات رسالية عن مهمتهم الحضارية التي يرون أنها تعفيهم عناء تعلم أي شيء عن العالم العربي بما في ذلك لغته وتقاليده، أو جاءوا من الداخل من تخصصات علمية بعيدة، لم يتعلموا في ظلها أصول العلم الاجتماعي.
وأما الطغاة فتسببوا في أمننة مزمنة لممارسة العلم الاجتماعي.
ثم يأتي الغلاة وهؤلاء يغالون إما في نرجسيتهم، أوفي التعصب المقيت لأيديولوجياتهم.
ثم الجفاة ويتنكرون للجذور الفلسفية المحلية ويسرفون في الاستعمال المشوه والغرضي والفوضوي لمفاهيم يجرى استيرادها ولم يتم استيلادها.
وأخيراً الجناة وهم من قتلوا أهم ما يميز العلم الاجتماعي: المنهاجية. هم مسؤولون عن حالة الأمية المنهجية المزمنة التي تفشت وجعلت العلوم الاجتماعية العربية تنتج كثيراً من اللا معنى.
فشل على فشل
وعند هذه النقطة أشير إلى أن عجز كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية العربية ليس إلا جزءًا من عجز أوسع تعيشه الدولة في العالم العربي. فالدولة كانت وستظل الموضوع الأول لتلك العلوم. فهي علوم دولة، وبالتالي فإن كل ما تعاني منه الدولة العربية تعاني منه أيضاً العلوم الاجتماعية العربية. وكما تمتلئ المنطقة بدول فاشلة ورخوة وهشة وحائسة وبأشباه دول، بل ودول شبهة، تخوض العلوم الاجتماعية العربية في ممارسات فاشلة ورخوة وهشة وحائسة ومشبوهة لا ينتج عنها معنى. وبدلاً من أن تشارك تلك العلوم في بناء قوة الدولة تحولت إلى شاهد على ضعفها. ولتوضيح التشابه بين الجانبين، أكتفي بالإشارة إلى أن الأزمات الخمسة التي تعاني منها الدولة العربية هي نفس ما تعاني منه العلوم الاجتماعية العربية والمعاهد القائمة على أمرها.
فالدولة في العالم العربي لم تتغلب أولاً على أزمة الهوية لكي تصبح وطناً يضم الجميع فيصطبغوا فيه بصبغة واحدة. وبالمثل تعاني العلوم الاجتماعية العربية من أزمة هوية، تتبدى في الفجوات العميقة بين القائمين بها وفي اغترابهم وعزلتهم عن بعضهم وفي عجزها عن انتاج خطاب علمي يكوّن تياراً رئيسياً من المشتغلين بها.
وتعاني الدولة في العالم العربي ثانياً من أزمة شرعية جعلتها تفتقر إلى الرضاء الشعبي والقبول المجتمعي بها وبما تؤديه. وتعاني العلوم الاجتماعية العربية بدورها من أزمة شرعية حيث ينقصها الاعتراف العام بجدارتها وقيمتها ناهيك عن عدم أخذها بجدية في صنع السياسات. كما تتبدى تلك الأزمة في ضعف مستوى اقبال الجمهور على انتاجها.
وتواجه الدولة في العالم العربي ثالثًا أزمة توزيع يعكسها غياب العدالة في تقاسم الثروة والسلطة. والعلوم الاجتماعية كذلك تعيش أزمة توزيع. فهي إلى الآن علوم عواصم وحواضر كبرى. هذا جغرافياً. أما مالياً فالقياس مع غيرها من العلوم لا ينصفها.
وتعجز الدولة العربية رابعًا عن حل أزمة التغلغل. فكثير من الدول العربية غير حاضر إلى الآن في كل ركن جغرافي من أركانها ولا في ذهن كل مكون من مكوناتها السكانية. والعلوم الاجتماعية كذلك، عجزت عن أن تتغلغل وتستقر بمعانيها الفلسفية العميقة في ذهن المشتغلين بها أنفسهم، فما بالنا بذهن الجمهور المستهدف منها.
وخامسًا تهدد الدولة في العالم العربي أزمة تكامل أفضت إلى اندلاع حروب أهلية انتهت بتفكك بعض الدول وتهديد بعض آخر منها بنفس المصير. والعلوم الاجتماعية العربية تعيش أزمة تكامل يعكسها غياب الحوار والميل إلى الانعزال التخصصي، والدخول في استقطابات فكرية ولغوية، كما تتجلى في معاناتها من التجزئة المفاهيمية وغياب المنهاجية وقلة الدراسات البينية عدداً وأثراً.
هذه الأزمات الخمس وكما أحالت الدولة في العالم العربي إلى تكوين ينتج كثيراً من اللا معنى يعج بالساكتين والمنسحبين والفارين واللاجئين واللا منتمين، تحيل العلوم الاجتماعية العربية بدورها إلى ساحات تزخر باللا منتمين من منتجي اللا معنى؟ ساحات ينفصل فيها الدال عن المدلول والكلمات عن المعاني بطريقة لا تختلف كثيراً عما بدر من ذلك المشجع الإنجليزي الذي أوحى نداءه بأنه يتشوق للصلاة بينما كان يتحرق من أجل لفت انتباه لاعب كرة.
--------------------------
بقلم: د. إبراهيم عرفات
(الجزء الثاني من ورقة بعنوان: العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية بين تغليب اللا منتمين وتغييب المعنى - دردشة مع الذات)
الجزء الأول من المقال